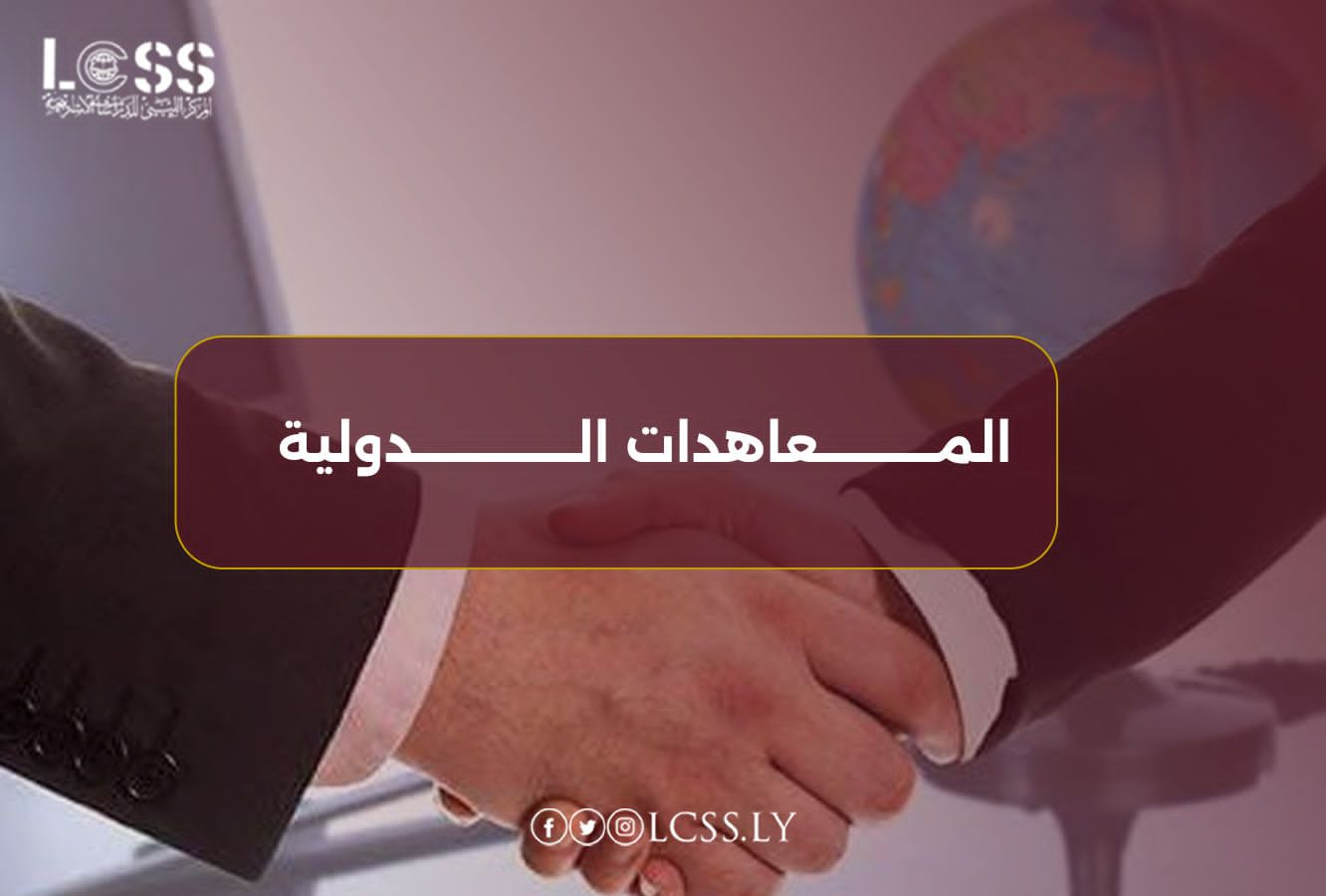تعتبر المعاهدات الدولية من أهم وسائل التعامل الدولي وقت السلم، وركيزة أساسية وضرورية للتعاون بين الدول، كما جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، إذ نصّت الفقرة الثالثة منه «على تحقيق العدالة، واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات بين الدول»
المعاهدة اتفاق يعقد بين أشخاص القانون الدولي. والشخصية الدولية كانت تقتصر على الدول إلى أن ظهرت المنظمات الدولية وأصبحت من أشخاص هذا القانون لكلمة معاهدة مرادفات كثيرة، مثل اتفاقية واتفاق وعهد وميثاق ونظام وعقد وإعلان وبروتوكول وتسوية... إلخ، وهي جميعها تتطلّب وجود وثيقة مكتوبة - على الرغم من أنّ تصريح ممثّل دولة ما ملزم لدولته كما جرى العرف الدولي - وانعقاد الوثيقة بين أشخاص القانون الدولي، وأن تكون لها نتائج قانونية تخضع للقانون الدولي. وتوجد نقاط مشتركة ما بين العقد والمعاهدة مثل الرضا الذي هو أساس الرابطة القانونية، ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، ومبدأ نسبية الآثار والنتائج. ومن أوجه الاختلاف، أن الإكراه في العقد يُفسد الرضا، ويُبطل العقد، أمّا في المعاهدة فقد كان مشروعًا قبل ميثاق الأمم المتحدة (معاهدات الصلح مثلًا.
تقسم المعاهدات الدولية إلى نوعين أساسيين:
المعاهدات الشارعة أو المشرّعة والمعاهدات التعاقدية. وتبرم المعاهدة مثل أي اتفاق دولي، وهذا الإبرام يمرّ بمراحل: المفاوضات، التحرير، الـتصديــق، فالـتـسـجـيــل والنشر، ويلي التسجيل في الدول الأطراف في المعاهدة، تسجيلها في الأمم المتحدة. ولا بد من توافر شروط التعاقد وهي: الأهلية، الرضا، مشروعية موضوع التعاقد، والتوافق بين الالتزامات الراهنة والسابقة.
مراحل إبرام المعاهدات الدولية :
1- المفاوضة:
وهي وسيلة لتبادل وجهات النظر بين ممثلين دولتين أو أكثر بقصد توحيد آرائهما ومحاولة الوصول إلى حل أو تنظيم لمسألة أو موضوع معين، ووضع الحلول أو التنظيم الذي يتفقون عليه في صورة مواد، تكون مشروع الاتفاق المزمع إبرامه.
وقد تجري المفاوضات في مقابلات شخصية أو في اجتماعات رسمية أو في مؤتمر دولي يجمع ممثلي الدولتين أو الدول المتفاوضة. وقد يقوم بأجراء المفاوضات رؤساء الدول مباشرة، ومن أمثلة ذلك، ميثاق الأطلنطي المعقود في 14/8/1941، إذا كان أحد المتفاوضين والموقعين عليه (روزفلت) رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك معاهدة التعاون والصداقة بين ألمانيا وفرنسا المعقودة في 22/ديسمبر/1973، إذا كان أحد المتفاوضين في عقده والتوقيع عليه الجنرال (ديغول) رئيس الجمهورية الفرنسية. ولكن في الغالب يقوم في التفاوض وزراء خارجية الدول أنفسهم وقد يقوم به ممثلو الدول المتفاوضة.
2- تحرير المعاهدات وتوقيعها:
إذا أدت المفاوضة إلى اتفاق وجهات النظر، تبدأ مرحلة تسجيل ما أتفق عليه في مستند مكتوب، وذلك بعد أن يتم الاتفاق على تحديد اللغة الواجب استعمالها في تحرير المعاهدة، فإذا كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغة واحدة ففي هذه الحالة لا تبرز أية صعوبة إذ تستعمل هذه اللغة المشتركة في تحرير المعاهدة (كما هو الحال بالنسبة للمعاهدات التي تعقد بين الدول العربية).
أما إذا كانت الدول المتفاوضة تتكلم لغات مختلفة فيتبع حينئذ أحد الأساليب الآتية:
أ- تحرر المعاهدة بلغة واحدة تختارها الدول المتفاوضة وقديماً كانت اللغة اللاتينية هي اللغة الدبلوماسية ولغة الاتفاقات الدولية أيضاً، ثم حلت محلها اللغة الفرنسية وبعد الحرب العالمية الأولى أخذت الإنكليزية تنافس الفرنسية.
ب- تحرر المعاهدة بلغتين أو أكثر، على أن تعطي الأفضلية لأحداهما بحيث تعتبر المرجع الأول الذي يعول عليه عند الاختلاف.
ج- تحرر المعاهدة بلغات جميع الدول المشتركة فيها، وتتمتع جميعها بالقوة نفسها وهذا الأسلوب قد يؤدي عملاً إلى مشاكل كثيرة في تفسير المعاهدات الدولية، فمن الصعب في كثير من الأحيان التعبير عن المعني أو المقصود على وجه الدقة بلغات مختلفة
3- التصديق:
أن التوقيع على المعاهدة – باستثناء الاتفاقات ذات الشكل المبسط – لا يكفي لكي تكتسب أحكامها وصف الإلزام، بل لابد من أجراء آخر يتلو التوقيع هو التصديق. والتصديق أجراء يقصد به الحصول على إقرار السلطات المختصة في داخل الدول للمعاهدة التي تم التوقيع عليها وهذه السلطات هي أما رئيس الدولة منفرداً، وأما رئيس الدولة مشتركا مع السلطة التشريعية، أو السلطة التشريعية لوحدها، وذلك تبعاً للنظم الدستورية السائدة في مختلف الدول.
ويكون التصديق إجراء لازماً، إذا ما نصت المعاهدة على ذلك، أو إذا ثبت بطريقة أخرى إن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق، أو إذا كان ممثل الدولة قد وقع على المعاهدة مع التحفظ بشرط التصديق، أو إذا بدت نية الدول المعنية في أن يكون التوقيع بشرط التصديق اللاحق من وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضة.
السلطة المختصة بالتصديق:
أولاً:- التصديق من اختصاص السلطة التنفيذية:
أن هذا الأسلوب، هو الذي كان متبعاً في ظل الأنظمة الملكية المطلقة والدكتاتورية، فقد عرفته فينسيا عندما كانت خاضعة للنظام الإمبراطوري (دستور عام 1852). واليابان منذ صدور الدستور عام 1889 حتى دستور عام 1946.
ثانياً:- التصديق من اختصاص السلطة التشريعية:
إن هذا الأسلوب، هو استثنائي أيضا، ويطبق في الدول التي تتبع نظام الحكم الجماعي، وهو النظام الذي كان متبعاً في تركيا منذ دستور عام 1924، واستمر حتى عام 1960. حيث كانت الجمعية الوطنية الكبرى تتمتع وحدها بحق التصديق على المعاهدات.
ثالثاً:- التصديق من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية:
إن توزيع حق التصديق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يعتبر القاعدة التي تتبعها غالبية الدول، غير أن تنظيم هذا التوزيع بين السلطتين يختلف من دولة إلى الأخرى. فأن معظم الدساتير الحديثة تنص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان للتصديق على كل المعاهدات تارة أو على المعاهدات الهامة تارة أخرى، وتضع الدساتير عادةً لائحة بالمعاهدات الهامة التي تخضع لموافقة البرلمان، وهذا الأسلوب الأخير هو الأكثر شيوعاً.
4 - التسجيل:
نصت المادة الثامنة عشرة من عهد عصبة الأمم على أن (كل معاهدة أو اتفاق دولي يعقد بين أعضاء عصبة الأمم يجب تسجيله في سكرتارية العصبة وإعلانه في أقرب فرصة ممكنة ولا تكون أمثال هذه المعاهدات والاتفاقات الدولية ملزمة إلا بعد هذا التسجيل)، وكان الباعث على تضمين عهد عصبة الأمم هذا النص، القضاء على الاتفاقات السرية، خصوصاً الاتفاقات العسكرية السرية التي تنطوي على تهديد للسلام العالمي وقد جاء في ميثاق الأمم المتحدة :
- كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وان تقوم بنشره بأسرع ما يمكن.
-لا يجوز لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع الأمم المتحدة.
تنفيذ المعاهدات
يبدأ تنفيذ المعاهدة الدولية عادة من تاريخ التنفيذ المنصوص عنه فيها، وإذا لم يُذكَر هذا التاريخ أو لم ترد الإشارة إليه في المعاهدة يعتبَر تاريخ تبادل التصديقات، أو إيداعها في المكان المعين هو تاريخ التنفيذ. وقد يكون للمعاهدة بعض النتائج والآثار قبل تنـفيـذهـا، كـمـقدمـات لهذا التنفيذ، كأن تضع إحدى الدول شروطًا معيّنة للبدء بالتنفيذ، مثل رفع الحجز عن أرصدة لها محتجزة في دولة طرف في المعاهدة. وقد يكون التنفيذ متدرّجًا كأن يقوم كل طرف بإجراء يقابله إجراء من الطرف الآخر أو الأفرقاء الآخرين في المعاهدة المتعددة الأطراف، أو أن يتمّ التنفيذ بالتدرج وفق مراحل محدّدة، تكون الأطراف نفّذت خلالها الموجبات الملقاة على عاتق كلّ منها. ويحدث أحيانًا أن يتم تنفيذ بعض الموجبات في المعاهدة قبل تصديقها، ولحين تصديقها، إلّا أنّ الدستور الفرنسي حرّم في العام 1958 تنفيذ معاهدة ما لم يتم التصديق عليها بعد. أما في المعاهدات التي يتم بموجبها إنشاء منظمات دولية، فإن الاتفاق ينص على تاريخ البدء بالتنفيذ بالنسبة إلى الأطراف، كما أنّه ينص على تاريخ بدء التنفيذ بالنسبة للدولة التي تنضمّ لاحقًا. وتصبح المعاهدة إلزامية للدولة التي تصادق عليها وفق قوانينها الداخلية، وسلطاتها المختلفة.
تضمّ المعاهدة أحيانًا ملاحق تنفيذية تعتبر جزءًا منها، وبخاصة إذا ما تضمّنت مواضيع تقنية شائكة تتطلب خبرات وتقنيات متطورة. وقديمًا كانت تطلب ضمانات للتنفيذ من دولة ما، أو من مجموعة دول، من خلال بعض الإجراءات مثل احتلال إقليم، أو تخصيص مورد مهم من موارد الدولة لضمان تنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقها. مع ظهور المنظمات الدولية والعمل بالمواثيق الدولية المعاصرة أبطِلت هذه الإجراءات. ويمكن اليوم الاستعانة بإحدى المنظمات الدولية التي تتمتّع بالحيادية والاختصاص للمساعدة في تنفيذ التعهدات المتبادلة. والمثال الأبرز على ذلك، الاتفاق النووي الإيراني مع الدول الكبرى أو ما يعرف بـ«ميثاق العمل المشترك». فقد كلّفت هيئة الطاقة النووية الدولية الإشراف التقني على المنشآت النووية الإيرانية، وضمان الجانب التقني من المعاهدة عبر إخضاعها للتفتيش الدوري، والتأكد من أعمال التخصيب وسقفه التقني، وسلميّة المشروع بمجمله، وطمأنة الدول الكبرى، على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ موجباتها. وتتمثّل هذه الموجبات برفع الحجز عن الأرصدة الإيرانية المودعة في المصارف الغربية، ثم العودة إلى مجلس الأمن لاستصدار القرارات اللازمة لرفع الحظر المالي والتجاري والحصار الاقتصادي عن إيران.
قد تكتشف الدول غموضًا في بعض بنود المعاهدة أو في نص من نصوصها أو تناقضًا فيها، ويكمن الحل بالعودة إلى روح المعاهدة وإلى قواعد الأخلاق والعدالة. وعلى الدول أن تلجأ إلى الوسائل السلمية لحلّ مثل هذه المسائل، وإذا تعذّر ذلك، عليها اللجوء إلى التحكيم الدولي أو القضاء الدولي، وأما إذا أقدمت إحدى الدول الأطراف في المعاهدة على إلغاء المعاهدة من جانبها أو الانسحاب منها أو اتخاذ قرار باعتبارها غير موجودة بعد سنتين من بدء التنفيذ، فإنّنا نصبح أمام مسألة تتعلّق بآثار المعاهدة.
آثار المعاهدات
للمعاهدات الدولية عدّة آثار تطاول أطرافها والغير، والدولة الموقّعة وقوانينها الداخلية. وسيقتصر بحثنا على آثار المعاهدة على أطرافها.
تختلف الآراء في الفقه الدولي حول تحديد الأساس القانوني لصفة الإلزام، ومنها في هذا المجال أنّ إرادة الدولة هي الأساس، وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين هي الأساس، وثمّة من يعتبر أنّ الضرورات السياسية وأدبياتها، والتوازن والاستقرار في المبادلات الدولية هي الأساس. إلّا أنّ ما يُجمع عليه الفقه الدولي ويذكّر به دائمًا هو الصفة الإلزامية للمعاهدة.
في هذا السياق يمكن التساؤل حول النتائج المترتبة على إلغاء الولايات المتحدة الاتفاق النووي مع إيران بعد سنتين من بدء التنفيذ، والمحددة مدته بعشر سنوات، بحجة أن إيران لم تحترم روح الاتفاق. إنّ إلغاء المعاهدة من قبل دولة طرف فيها لا يلغيها من وجهة نظر القانون الدولي وبخاصة قانون المعاهدات. وتعتبر الجهود المبذولة من قبل الدول الأطراف في المعاهدة من قبيل الوسائل السلمية لتجاوز الخلافات حولها.
لقد نصّ النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والذي يعتبر جزءًا من الميثاق الأممي، على أنّ صلاحية تفسير أي معاهدة دولية تعود إلى هذه المحكمة، كما يعود إليها تحديد الالتزامات المتبادلة. ولما كانت المحكمة تصدر فتاوى في الاستشارات التي تطلبها الأمم المتحدة، فإنّ هذه الاستشارات غير ملزمة للدول إلّا من الناحية المعنوية. وعندما تختار الدولة رفع دعوى أمام هذه المحكمة، فإنّ الحكم الصادر أيضًا غير ملزم، ما لم تصرح الدولة صاحبة العلاقة بالقبول بالحكم قبل إجراءات الدعوى، ففي هذه الحال يكون الحكم الصادر عن المحكمة ملزمًا لطرفيّ الدعوى.
أخيرًا، إنّ الانسحاب بطريقة تعسّفية من أي معاهدة دولية يعرّض السلم والأمن الدوليّين للخطر في ظل عدم الاستقرار في العلاقات الدولية عدا عن كونه مخالفًا للمواثيق الدولية والأعراف.