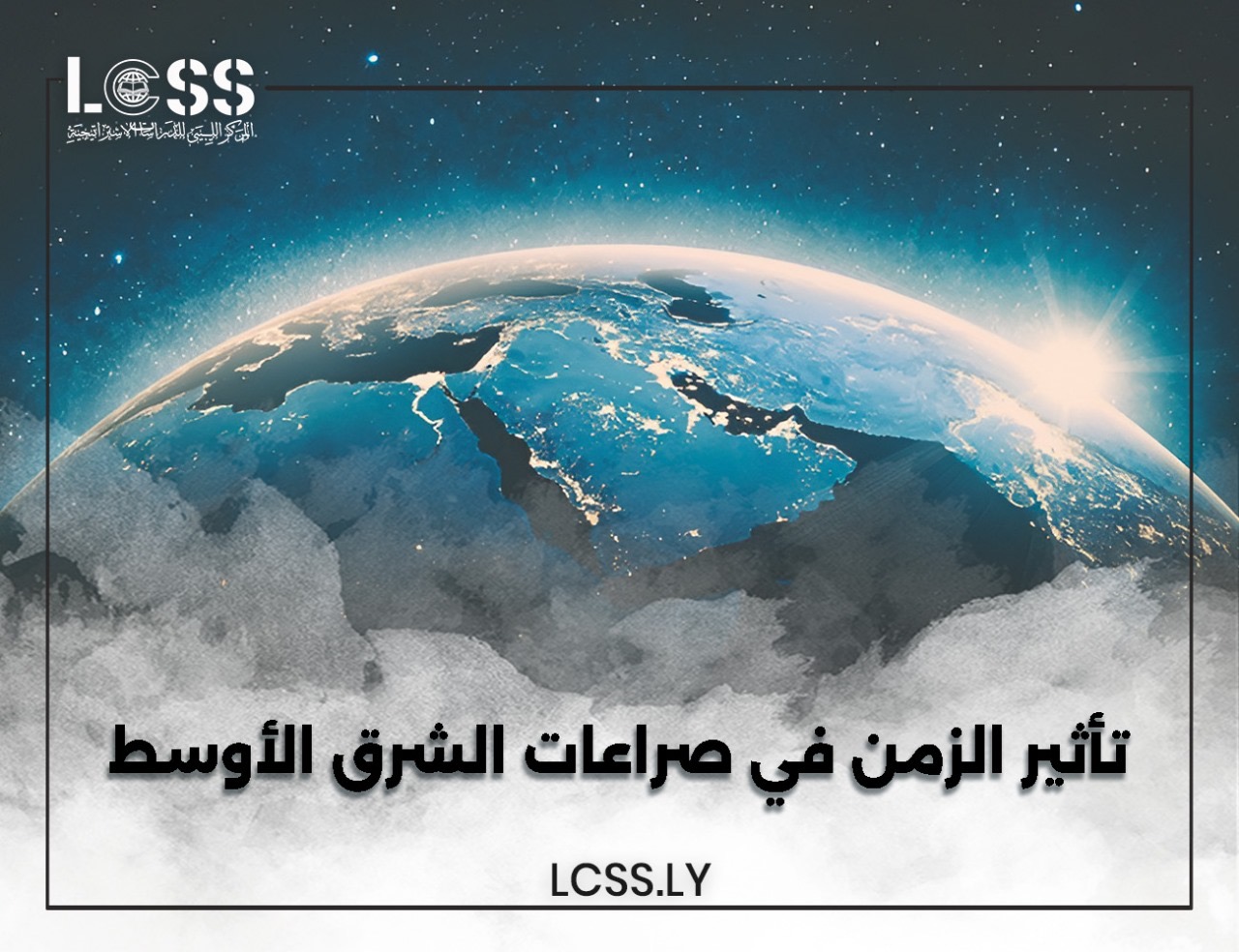ما بين أن نولد ونموت زمن محدود لا يعادل في مسار الكون سوى ومضة سرعان ما تنطفئ قد تصبح تلك الومضة مورداً وقيمة للحرية والسلام والتنمية والعدالة في بعض الدول والمجتمعات، بينما تتعرض في سياقات أخرى إلى الهدر بفعل الاستبداد والصراع والفقر والظلم تتراكم تلك الومضات على مدى أزمنة ممتدة لتخلق إرثاً تاريخياً وذاكرة جماعية تؤثر في حاضر ومستقبل المجتمعات وعندما تتلاقى تراكمات الزمن مع المكان والثقافات والهويات ونمط علاقات القوة والسلطة، فإنها تشكل حالة السياسة خلال فترة معينة من حياة الدول والمجتمعات
قد يكون الزمن، في حد ذاته، مجالاً لممارسة السلطة أو القوة أو أداة مؤثرة في صنع القرارات والسياسات أو مدخلاً لفهم وتشكيل ما يجري في محيطنا من تفاعلات سياسية سواء داخل الدول أو السياسة العالمية ذلك أن نتائج قرار سياسي أو رواج خطابات معينة أو فعالية تدخلات خارجية لتسوية صراع ما أو إدارة العلاقات بين الدول قد تختلف من سياق زمني إلى آخر بل إن الزمن قد يخضع للتسييس، عندما يستخدمه المتنافسون على السلطة والثروة في تبرير نشوب صراعاتهم إما بالعودة لمظالم الماضي أو أزمات الحاضر، حيث يرتبون الأحداث وتسلسلها زمنياً بطريقة تشرعن مطالبهم وأدوارهم وتجتذب المؤيدين
على هذا الأساس، تستكشف تلك الورقة ارتباطات الزمن والسياسة، بهدف إسقاطها على ظاهرة الصراعات مع الاستدلال بحالة الشرق الأوسط التي تتسم فيها تلك الصراعات بامتدادها الزمني منذ استقلال دولها قبل أكثر من سبعة عقود عن الاستعمار الغربي تكمن أهمية ذلك في أن العامل الزمني لا يساعد، فحسب، على فهم الواقع الصراعي ودينامياته ونتائجه، إنما يحمل دروساً قد يدركها بعض المتنازعين فتنعكس على استجاباتهم السياسية، بينما قد يتجاهلها آخرون، فيعيدون أخطاء الماضي في الحاضر والمستقبل، وكأن الزمن لديهم وعاء فارغ لا يترك بصماته على مدركاتهم وسلوكياتهم السياسية
آثر الزمن بين السلطة والسياسة
قد يبدو مفهوم الزمن يسيراً ومحايداً، عندما يشير إلى مدة أو وقت أو فترة زمنية سواء طالت أم قصرت، لكنه في واقع الأمر ينطوي على تعقيدات هائلة بسبب اختلافات النظرة له في مجالات كالفيزياء والفلسفة والاجتماع والأدب، ناهيك عن أنه يخضع بالأساس لتأويلات متعددة ترتبط بالثقافات الاجتماعية، من حيث كونه مورداً أو قيمة أو مخزناً للذاكرة أو العيش في الحاضر أو التطلع للمستقبل
بشكلٍ عام، يعني الزمن تقدماً مستمراً للأحداث والاتجاهات والظواهر من الماضي إلى الحاضر والمستقبل، وهي عملية متحركة قد تتسارع أو تتباطأ وتيرتها، وفقاً لنمط تفاعلها مع المكان والأفكار والبشر، لكن لا رجعة فيها، فضلاً عن أنها أكثر شمولاً من مفهوم الوقت، كمدة فاصلة ومحددة بين حدثين يمكن قياسها، كما أنها ترتبط في السياسة بدلالات التطور والتقدم والتغيير والجمود والاضمحلال لأحوال الدول والمجتمعات فيما يفرق البعض بين الزمن اللغوي الذي له صلة بمتى وقع حدث ما، والزمن الفلسفي (الزمان) الذي يعبر عن الامتداد أو الدهر أو الأجل أو السرمد أو الأبد
لهذا الزمن، أنماط عديدة من حيث مساراته منها: الزمن الخطي (مسار مستقيم للأحداث)، والزمن الدائري (إعادة إنتاج الأحداث)، والزمن السحيق (تاريخ الأرض على مدى ملايين السنين)، أو حتى الزمن المتخيل، أي بناء زمن مغاير للواقع بغرض نقد الزمن الحقيقي وإنماء القدرة الإنسانية على الابتكار، على نحو يظهر كثيراً في الروايات الأدبية يتمدد هذا التخيل الزمني إلى السياسة، عند بناء سيناريوهات "ماذا لو"؟ كأن نتصور أن الشرق الأوسط مضى في مسار زمني مغاير بلا صراعات أو حروب، أي يتم وضع معطيات متخيلة لدول المنطقة، ثم دراسة أنماط تفاعلاتها ونتائجها البديلة على مختلف الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليتم مقارنتها بالمسار المأزوم الراهن للمنطقة بغرض استخلاص الدروس من كلفة استمرار الصراع وعوائد السلام، أي تقييم الفرص الزمنية المهدرة في المنطقة
بتعقد فكرة الزمن وأنماطه المتداخلة، اقتصر الاهتمام به في السياسة على منطق تأريخي تسجيلي وتأطيري، وهي مسألة مؤثرة في فهم الأحداث والاتجاهات والظواهر، لأنها تضع اللبنة الأولى في خارطة الإدراك السياسي لكن عالم الاجتماع جورج واليس تجاوز هذا الأمر في السبعينيات إلى وضع الزمن كعامل مؤثر في بنية التفاعلات السياسية، عندما طرح مصطلح السياسة الزمنية chronopolitics ليعبر عن الارتباطات الوثيقة بين السلوكيات السياسية للأفراد والجماعات ومنظوراتهم الزمنية التي قد تفسر مسارات التغيير والتنمية خلال فترة معينة من حياة الدول والمجتمعات من بعد ذلك، تدفقت رؤى عديدة انتقلت بالزمن من الماضي والحاضر إلى المستقبل الذي قد يكون مجالاً لصراعات القوى السياسية الاجتماعية، عندما تتنافس رؤاها في حل الأزمات إما بمنطق النظرات السياسية طويلة أو قصيرة الأمد
لقد انبنت تلك الارتباطات على أن الزمن سواء أكان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل يصوغ بالأساس إدراك البشر وفهمهم لما يمر ويحيط بهم من أحداث، ومن ثم قد يؤثر على قيمهم وهوياتهم واستجاباتهم السلوكية من هنا، أخذت دراسة علاقات الزمن والسياسة زاويا عديدة ومختلفة الاتجاهات فقد تسيطر الدولة القومية الحديثة على الزمن كتعبير عن سيادتها، فهي تملك سلطة تحديد التقويم الزمني، وتنظيم الاستحقاقات السياسية والدستورية والانتخابية في مواعيد معينة علاوة على أنها تربط اكتساب أو إنكار حقوق المواطنة مثل الجنسية بإجراءات لها جداول زمنية تحددها السلطة لكن عصر العولمة وثورة الاتصالات والتكنولوجيا أديا إلى تسريع التدفقات العابرة للحدود، ومن ثم ضغط الزمان والمكان بما قاد إلى اختراق سيادة الدولة على البعد الزمني
من جانب آخر، ينظر للزمن كمعنى سياسي قد يسهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية، لا سيما مع الأثر الممتد لذاكرة الماضي على تفاعلات الحاضر والمستقبل، على غرار إحياء ذكرى الإبادة والحروب لتعزيز المشاعر الوطنية في الدول في مراحل ما بعد انتهاء الصراعات نالت كذلك الدورة الزمنية لنمو وصعود الإمبراطوريات ثم انهيارها اهتماماً واسعاً في الدراسات، حيث يصبح عندها المسار السياسي دائرياً متكرراً، كنظرة ابن خلدون حول أطوار السلطة من الولادة والنمو إلى الزوال على غرار حياة الإنسان ذاتها لكن تلك الدورة، التي نظر لها البعض على أنها حتمية بفعل وقائع تاريخية، تعرضت إلى نقد كونها تتحدى قدرة العقل والبشر أنفسهم على إمكانية تلافي مسارات الانهيار عبر إصلاح العوامل التي تقود لذلك
إجمالاً، هنالك اتجاهات أساسية للارتباط بين الزمن والسياسة قد تساعد عند فهم تجلياتها في ظاهرة الصراعات، أولها، سياسة الزمن The Politics of Time، أي أن السياسة تنظم الزمن وتديره كجزء من عمليات الهندسة السياسية والاجتماعية وإدارة العملية الإنتاجية وصحة القوى العاملة والاستهلاك مثل: التوقيت الصيفي وطول يوم العمل ثانيها، زمن السياسة The Time of Politics، أي أن الزمن يصبح جزءاً من بناء سياسات الدول وإدارة علاقات القوة وعمليات صنع القرار والاستحقاقات السياسية وضغوطات الوقت في الأزمات والصراعات أما الاتجاه الثالث، فيتعلق بتسييس الزمن Politicized Time، أي استخدام الزمن لتحقيق أغراض سياسية عبر المماطلة أو الصبر أو استحضار الماضي لشرعنة سياسات الحاضر، على نحو يظهر مثلاً في خطابات استعادة الماضي الذهبي في سياسات ترامب لإعادة أمريكا عظيمة مرة أخرى
تفسير الزمن للصراعات
في ظاهرة الصراعات سواء أكانت داخلية أم خارجية، يتجاوز الزمن مجرد تسجيل أحداثها وتطوراتها، حيث قد يتحول إلى موضوع للنزاع أو مدخل لتفسير توقيتات نشوبها، فضلاً عن التأثير في دينامياتها ونتائجها يتأسس ذلك الفهم على أن الصراعات تعبر، في جوهرها، عن تناقضات حول القيم أو المصالح بين الأفراد أو الجماعات أو الدول، يتم إدارتها بوسائل سلمية أو عنيفة تلك التناقضات لا تنشأ بمحض الصدفة، إنما بفعل تفاعلات تراكمية في مكان وزمان، وبخصوص قضايا معينة محل نزاع قد يتخذها أطراف الصراع في لحظة ما مبرراً لإشعاله
داخلياً، قد تكون تلك القضايا محل الصراع: الإقصاء من السلطة أو الثروة أو انتشار الفقر أو البطالة أو التفاوت الاقتصادي-الاجتماعي أو التهميش الهوياتي، بينما قد تشمل خارجياً: الصراع على الموارد أو الحدود أو الأمن أو النفوذ الخارجي أو غيرها ولا يمكن تفسير ظاهرة الصراعات دون معرفة ماضيها الزمني المتراكم أو فصلها عن تصورات المتنازعين وأجيالهم المختلفة لقضايا الصراع سواء في الحاضر والمستقبل، لأن ذلك قد ينعكس على خطاباتهم واستجاباتهم السلوكية
عندما تنشب الصراعات وتسلك طريقها نحو مرحلة الحرب التي تواجه الدولة فيها تمرداً مسلحاً أو قوة خارجية تنزع سيادتها على مناطق جغرافية في البلاد، فإن سلطتها تتراجع على الزمن في تلك المناطق، كجزء من إدارة وتنظيم الحياة اليومية للسكان يتمدد الزمن ليؤثر في نتائج الصراعات، بحسب مدتها الزمنية سواء أكانت قصيرة أم طويلة الأمد، فالنتائج المترتبة على الحروب الخاطفة قد تختلف عن نظيرتها الطويلة الممتدة كذلك الأمر، فإن اختيار اللحظات المناسبة للتدخل في الصراع يشكل عاملاً أساسياً في مدى فعالية دور الأطراف الثالثة في منعه مبكراً، أو الحد من تأثيراته، أو تسويته، فضلاً عن أن ضيق الوقت أو اتساعه قد يلعب دوراً مؤثراً في التوصل إلى اتفاق تسوية من عدمه، وفقاً لطبيعة أطراف الصراع وحجم القضايا واتساعها من عدمه
في مرحلة إدارة التفاوض حول وقف إطلاق النار أو التسوية، يعادل الزمن فعلياً وليس رمزياً أرواح بشر قد يموتون أو يظلون أحياء وإذا تمت تسوية الصراعات، فالمسار الزمني بعدها قد يشكل فرصة لتقييم مدى قدرة أطراف النزاع على الالتزام بتعهداتهم في بناء السلام سواء أكانت بناء دستور جديد أو عقد انتخابات أو إنفاذ آليات العدالة الانتقالية من لجان حقيقة ومساءلة ومصالحة ناهيك عن تعرض الزمن للتسييس في إدارة ديناميات الصراع عبر استدعاء الماضي في سردية المتنازعين لحشد وتعبئة أنصارهم أو انتهاج الصبر أو دبلوماسية شراء الوقت كتكتيك تفاوضي أو حتى تجميد الصراع لفترة زمنية إلى أن تتاح الفرصة لتغير قواعد اللعبة أو توازنات القوى مستقبلاً
بما أن البعد الزمني يتخلل كافة تفاعلات ومراحل الصراع، فيمكن التركيز على بعض الجوانب على سبيل المثال لا الحصر- التي يظهر فيها ذلك البعد كموضوع أو مُفسِّر أو أداة مؤثرة في الصراعات مع الاستدلال بحالات صراعية شرق أوسطية، وذلك على النحو الآتي:
1 - أوقات نشوب الصراع: يرتبط وقت نشوب صراع ما ببلوغ تناقضاته في لحظة زمنية معينة حداً لم يعد فيها مفر من النزاع بين أطرافه، فهي لحظة ينتقل فيها الصراع من الكمون إلى العلن أو من إدارته سلمياً إلى الصدام بدرجاته ومستوياته المختلفة وصولاً إلى الحرب الشاملة هنا، يدخل العامل الزمني في بنية الصراع بطرق مختلفة متأثراً ومتداخلاً مع عوامل أخرى فقد يمثل الزمن، كوقت مادي أو طبيعي، أهمية في تحديد قرارات أطراف النزاع في بدء شن الحرب أو الهجمات المسلحة في فترات أو مواسم معينة في العام إذ اتجهت بعض الدراسات إلى الميل بأن الصراعات العنيفة قد تبدأ في الربيع والصيف وتتراجع في الخريف والشتاء
2 - بناء سردية الصراع: يلعب العامل الزمني دوراً أساسياً في بناء سردية الصراع، فالمتنازعون يعملون على صياغة رواية لتبرير ذلك الصراع تتضمن ترتيب الأحداث وتسلسلها زمنياً والترابط فيما بينها، كي يضفون شرعية على أنفسهم ويؤطرون طبيعة استراتيجياتهم وأدوارهم ومصالحهم وتخلق طريقة سرد الصراع تلك منطقاً أو علاقات سببية تمنح المخاطبين بها المعنى لما يجري حولهم من أحداث وتفاعلات سياسية فمن خلال سردية الصراع، يمكن فهم الحقائق، وهياكل السلطة، وعلاقات القوة، والربط بين الحاضر والماضي والمستقبل في مسار زمني متصل يعزز لديهم الهوية، ويحفز الذاكرة الجماعية
3- مسار مراحل الصراع: تأخذ مراحل الصراع مساراً زمنياً خطياً يبدأ من الكمون ثم البزوغ والتصاعد، مروراً ببلوغ نقطة الأزمة والحرب، ليعقب ذلك تخفيض لحدة الصراع، ثم وقف لإطلاق نار وتسوية يعقبها مرحلة بناء السلام هذا المسار، الذي ينتقل من الصراع إلى السلام، تتعدد أشكاله ومراحله في الأدبيات الغربية والتي تستدمج نظرة لفكرة الصراع على أنه عملية تطورية للمجتمعات والدول، قد تبدأ من الفوضى لتنتهي بالتعايش، وهو ما قد يفيد في فهم مسار الصراع ومعرفة أي مرحلة يمر بها ويمكن فيها تسويته
4- المدة الزمنية للصراع: سواء أكان المسار الزمني للصراع خطياً مستقيماً أو دائرياً أو حتى متقطعاً أو عالقاً دون تسوية على أرض الواقع، فإن المدة الزمنية التي تأخذها مراحل ذلك الصراع قد تحدد حجم الخسائر البشرية والمادية، ناهيك عن أنها تؤثر في نتائج الصراع نفسه هنا، طرحت أدبيات الصراع العديد من المتغيرات التي تحدد طول أو قصر مدة الصراع من أبرزها، مدى تعقد قضايا الصراع (كلما كانت تعبر عن مظالم هيكلية وهوياتية وعرقية طالت مدتها الزمنية أكثر)، طبيعة التدخلات الخارجية (تمنح مغذيات كالموارد المالية والسلاح والدعم السياسي لأطراف القتال الداخلي للاستمرار في الصراع لأطول مدة)، نمط جغرافيا الصراع (طبيعة التضاريس الجغرافية الوعرة قد تجعل الصراع أطول مدة)، حسابات قادة الصراع لتكلفة وعائد استمرار الصراع (كلما زادت التكلفة البشرية والمادية قد تنزع أطراف النزاع لوقف القتال وتقصير مدة الحرب على أساس أنهم قد يفقدون حواضنهم الاجتماعية)، وأخيراً حدود الفجوات في القدرات العسكرية والقتالية والتكنولوجية بين المتنازعين
5- من لحظة النضج إلى التحول: في أدبيات الصراع، طرح وليام زارتمان ما يسمى باللحظة الناضجة Ripe Moment، أي الوقت الذي يجد فيها أطراف النزاع أنفسهم عالقين في مأزق صراعي بدرجات مختلفة، فلا يستطيعون تحمل كلفة جمود الصراع وعدم حسمه، وبالتالي يبحثون عن مخرج بديل في تلك اللحظة، يمكن للأطراف الثالثة التدخل لحث المتنازعين على التفاوض أو وقف اطلاق النار أو التسوية لكن لحظة النضج تتطلب ليس فقط شرطاً موضوعياً يتعلق بحسابات الرشادة للمتنازعين حول المكسب والخسارة من استمرار الصراع العسكري، وإنما شرطاً ذاتياً، يتعلق بمدى إدراك أطراف النزاع لتلك اللحظة، بما ينعكس ذلك على استعداداهم للتفاوض للخروج من المأزق المتبادل، والأهم، مدى إدراك الأطراف الثالثة (وسطاء السلام) للحظة النضج تلك للتدخل لتيسير التفاوض والتوصل إلى وقف إطلاق النار
المعضلة أن لحظة النضح في صراعات الشرق الأوسط لا تجرى فقط نتاجاً لحسابات أطراف النزاع في الداخل لكلفة وعائد استمرار الصراع، بل ترتهن أيضاً بالأساس بقوى خارجية ترعى أولئك الأطراف في سياق الحروب بالوكالة في المنطقة، لهذا اختلف توقيت تلك اللحظة وملابساتها من صراع إلى آخر في المنطقة في ليبيا بلغ الصراع العسكري نقطة النضح من أجل وقف إطلاق النار بعد فشل معركة طرابلس في 2019 في الحسم بين الشرق والغرب، فضلاً عن رؤية القوى الإقليمية الداعمة لأطراف النزاع أن محاولة الحسم قد تؤدي إلى حرب إقليمية، وهو ما قاد إلى التوصل إلى اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020
الملاحظ في تلك الصراعات أنه حتى لو بلغت الأطراف لحظة نضج تقضي بوقف إطلاق النار، فلا يفضي ذلك إلى تسوية الصراع بسبب حسابات أطراف النزاع أو رعاتهم بأن وقف النار قد يكون فرصة لالتقاط الأنفاس لإعادة تجديد الموارد في مسعى لحسم النزاع أو أن أطراف الصراع الأهلي وداعميهم من الخارج لم يصلوا سوياً إلى لحظة النضح بشكل متعادل بالتالي، فإن نقطة النضح في صراعات الشرق الأوسط قد تصبح مؤقتة أو تنتظر زمنياً حدوث نقطة تحولTipping point يختل عندها توازن القوى في فترة زمنية معينة، مما يؤدي إلى تأثيرات كبيرة قد يستغلها أحد أطراف النزاع للحسم الميداني
في سوريا، استغلت المعارضة المسلحة بدعم تركي التداعيات الإقليمية لحرب إسرائيل على غزة ولبنان التي أضعفت حلفاء الأسد خاصة إيران وأذرعها المليشياوية للإطاحة به في 8 ديسمبر 2024 بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر في العام نفسه مع الأخذ في الاعتبار، تزامن تلك اللحظة مع عوامل أخرى تحفز عليها، مثل: إنهاك الجيش السوري على مدى أكثر من عقد من الحرب الأهلية، تراجع الموارد الاقتصادية للنظام وتآكل الولاء له، انتشار الفساد والفقر والبطالة، عدم قدرة روسيا على مواصلة دعم نظام الأسد في ظل ضغوطات الحرب في أوكرانيا
يمكن القول إن إدراك المتنازعين للحظة اختلال توازنات القوى في الصراع قد يؤثر في مدى قدرتهم على استغلال نقاط التحول لصالحهم ربما يساعد هذا المنطق في فهم لماذا توسع إسرائيل عدوانها من غزة إلى لبنان وسوريا واليمن، حيث توظف ميل موازين القوى الإقليمية لصالحها ودعم الإدارة الأمريكية لها وغياب أي نوع من الردع الإقليمي، لتحقيق أهداف استراتيجية كتهجير الفلسطينيين وإضعاف أكبر لإيران وحلفاءها، وتحييد سوريا من معادلة الصراع العربي-الإسرائيلي في المقابل، تستغل تركيا نقطة التحول تلك في سوريا بعد سقوط الأسد لإنهاء ضغوط اللاجئين السوريين على الداخل التركي، وإضعاف حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا، وتحجيم الأكراد في سوريا، ناهيك عن امتلاك ورقة تساومية من خلال نفوذها على نظام الشرع سواء مع روسيا أو الولايات المتحدة
نتائج وإشكاليات التكلفة الزمنية
ما سبق ليس إلا محاولة استشكافية لفهم أثر العامل الزمني في ظاهرة الصراعات بشكلٍ عام وخصوصاً في حالة الشرق الأوسط، وهي لا تخلو أساساً من إشكاليات وتحديات عديدة، تبدأ من معضلة الأفهام العديدة للزمن والاختلافات الثقافية والاجتماعية في تقدير قيمته وانعكاس ذلك على مدى الحساسية السياسية له من قبل أطراف الصراع، مروراً بطبيعة التصورات المتناقضة للمتنازعين حول الماضي والحاضر والمستقبل، وانتهاءاً بتنوع التوظيفات السياسية للعامل الزمني في مراحل الصراعات من سياق إلى آخر
مع ذلك، يمنح العامل الزمني في صراعات الشرق الأوسط دروساً، أهمها، أن مضي تلك الصراعات في مسار ممتد دون توقف يعبر عن إهدار زمني، حيث يتحول الوقت من كونه فرصة لرفاهية الأفراد والمجتمعات إلى تكلفة مؤلمة لها ينتج عنها ضحايا وتردٍ للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، فواحد من كل ثلاث حالات نزوح في العالم تقع بالأساس في المنطقة، خاصة في سوريا واليمن والسودان، بينما تسهم دول الشرق الأوسط بـ15 مليون لاجيء، غالبيتهم من سوريا وفلسطين والسودان
يعاني أيضاً سكان دول الصراعات كسوريا واليمن والسودان وغزة عدم استقرار أمني وفقراً وبطالة واحتياجاً إنسانياً، أضيف عليه مؤخراً التجويع العمدي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية، على النحو الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة وسط صمت إقليمي يتجاهل درساً تاريخياً بأن عدم ردع المعتدي يغريه بتوسيع عدوانه بل وفرض هيمنته مستقبلاً بل إن تكلفة تلك الصراعات قد تمتد إلى زمن المستقبل، عندما يزداد ميل الأجيال الشابة للهجرة من المنطقة بحثاً عن بيئات آمنة ومستقرة أو تتحول إلى مخازن بشرية يملؤها الاحتقان والغضب لتصبح وقوداً لجماعات مسلحة
إذ تشير العديد من الدراسات إلى أن الشباب، وهم غالبية سكان المنطقة، يشكلون الهيكل الأساسي للمقاتلين في الحروب الأهلية وحركات التمرد، لسببين: الأول، أن لديهم تكلفة منخفضة في خوض غمار العنف، كونهم لم يندمجوا في القيود السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمرحلة البلوغ مثل التوظيف والزواج والثاني، أن عمليات التحديث التي جرت في الدول، كالتعليم، رفعت سقف التوقعات للشريحة الشبابية، ومن ثم تقود إلى نشوء ما يعرف بالحرمان النسبي، عندما لا تلبي الدول توقعات تلك الشريحة السكانية، مما قد يزيد السخط وتحفيز الانضمام لحركات التمرد أو الاحتجاجات العامة
يشي كذلك المسار الممتد لصراعات المنطقة بنوع من سوء الممارسة السياسية الزمنية، حيث قد لا تترك دروس الماضي أثراً في إدارة أزمات الحاضر أو بناء تصورات المستقبل، فغالبية الصراعات وإن اختلفت خصوصيات دول الصراعات نشبت بفعل اختلالات هيكلية سياسية واقتصادية واجتماعية لم تجد علاجات جذرية لها من قبل الأنظمة السياسية، والتي قد تلجأ في المقابل إلى سياسات السيطرة بالقوة وممارسة التسلط واستئثار شبكات زبائنية موالية لها بالموارد، مما يولد عنفاً زمنياً ومكانياً بطيئاً ومتدرجاً يتحول في وقت ما، من خلال شرارات احتجاجية أو تمردات مسلحة، إلى عنف مباشر يدخل دول المنطقة في دائرة صراعية مفرغة بلا توقف
ما إن ينشب الصراع العنيف في دول المنطقة، حتى يصبح توقفه أو تسويته أمراً صعباً ومعقداً، كونه قد يتعرض للعسكرة ونزع سيطرة الدولة على وظيفة احتكار العنف، فضلاً عن أنه يجتذب قوى خارجية إقليمية ودولية متنافسة على النفوذ والمصالح قد تعيق تسوية الصراع وتمد أمده أو أن الصراع نفسه قد ينتج صراعات أخرى فرعية، أو شبكات مصالح تغذي استمراريته أو حتى تجمده دون سلام أو حرب، انتظاراً لفرصة زمنية قد تتغير فيها توازنات القوى
أخيراً، فإن حالة الصراعات في الشرق الأوسط ليست قدراً حتمياً لا فكاك منها، فالمنطقة عرفت تاريخياً فترات تعايش وسلام، لكن تحقق هذا الأخير يحتاج إلى تسويات عادلة وإصلاحات جدية للدولة سواء على مستوى قدرتها التمثيلية للمجتمعات أو الحد من انكشافها للخارج، فضلاً عن توافقات إقليمية حول ماهية الأمن والاستقرار الذي تحتاجه المنطقة لأنه مختلف على مضامينه ومتطلباته وآلياته، وحتى تحين الفرصة لتوافر ذلك، سيظل الشرق الأوسط غارقاً في صراعات مستمرة ربما قد تتجمد أو تخبو لكنها لا تنتهي
المصدر: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
الكاتب : د. خالد حنفي علي
التاريخ : 6/5/2025
---------------------------------------------------------------------------
المصدر: مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية
الكاتب : مرام أكرم
التاريخ : 5/2/2025