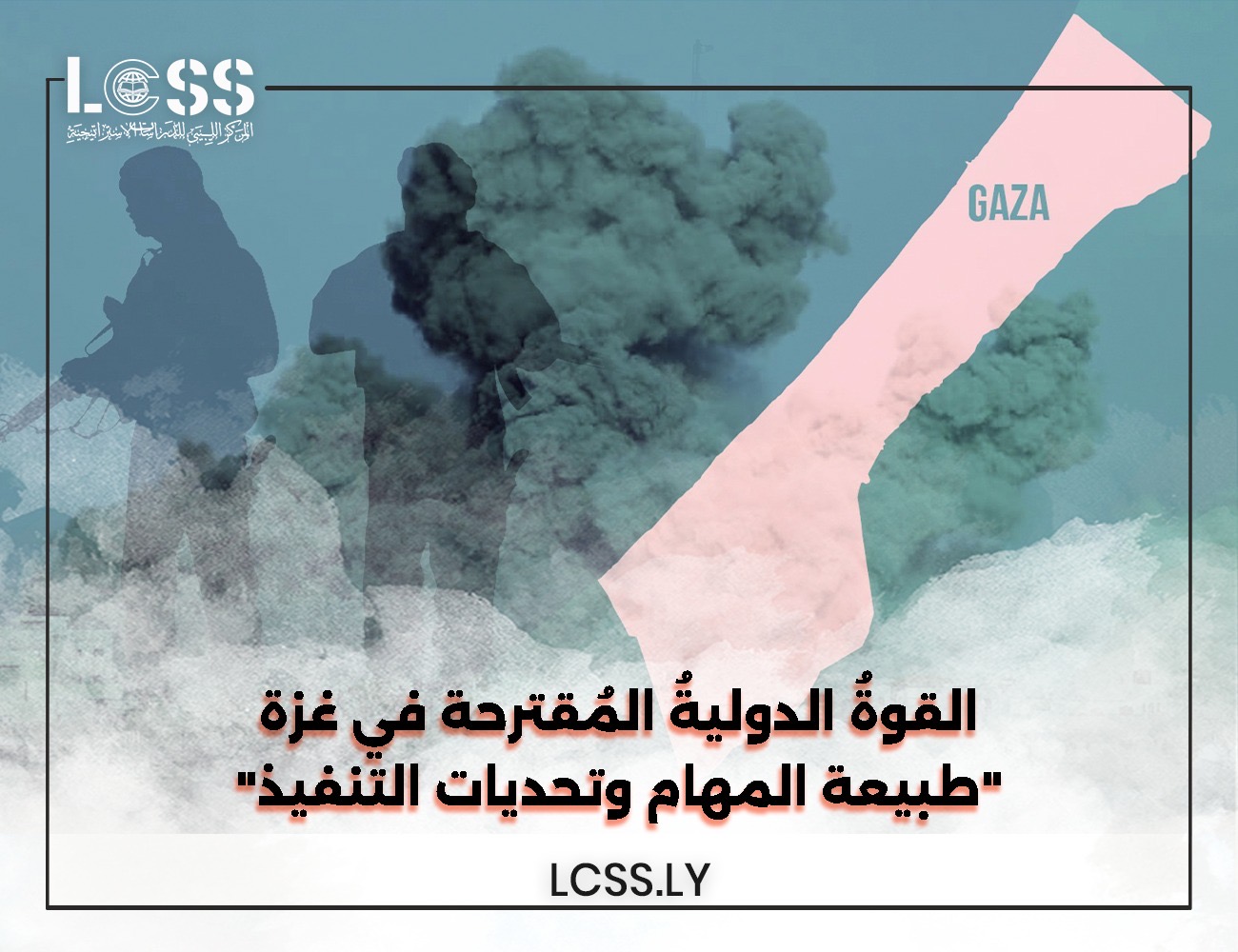يُثير البند المُتعلقُ بتشكيل قوةٍ دوليةٍ مُؤقتةٍ في قطاع غزة، والمعروفة باسم قوة الاستقرار الدولية المُؤقتة جدلًا واسعًا حول طبيعة هذه القوة وأهدافها وتحديات تنفيذها في ظلّ واقعٍ ميدانيٍ بالغ التعقيد، حيث أفضت خطة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التي أعلن عنها في 29 سبتمبر 2025 -الُمكوّنة من عشرين بندًا- في مرحلتها اللاحقة على تشكيل قوة استقرار دولية تُنشر فورًا في غزة، لتتولىَ توفيرَ التدريبِ والدعمِ لقواتِ شرطةٍ فلسطينيةٍ مُوافق عليها، والمُساهمة في إعادة بناء الحدّ الأدنى من مُقومات الأمن والإدارة بعد عامين من النزاع والدمار، غير أنّ هذا الطرح، رغم طابعه الإنساني المُعلن، يواجهُ إشكالياتٍ عميقةً وتحدياتٍ جوهريةً مما يجعله محفوفًا بتعقيداتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ مُتشابكة، وبالنظر إلى أهمية هذا المُقترح؛ فإنه يُمثّل نموذجًا جديدًا يختلف عن بعثات حفظ السلام التقليدية التابعة للأمم المُتحدة من حيث النشأة والتفويض وآليات القيادة، وعليه، تسعى هذه الورقة إلى تحليل طبيعة مهام القوة الدولية المُقترحة في غزة، واستعراض أبرز تحديات تنفيذها، ومُقارنتها بالنموذج الأممي لقوات حفظ السلام، بغرض تقييم مدى واقعية هذا الطرح وقدرته على تحقيق الاستقرار دون المساس بالسيادة الفلسطينية أو إعادةِ إنتاجِ أشكالٍ جديدةٍ من السيطرة الخارجية في ظل غيابِ إجماعٍ دوليٍ واضحٍ بشأن دورها وحدودها القانونية.
القوة الدولية في غزة: خصوصية التكوين والمهام
يُشكّل البند الخاص بإنشاء «قوة الاستقرار الدولية المُؤقتة» ISF أحد أبرز الُمخرجات الرئيسية لخطة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” المُعلنة في 29 سبتمبر 2025، ويأتي هذا التصوّر ضمنَ رؤيةٍ أميركيةٍ لإعادة تشكيل المشهد الأمني في القطاع عبر نشْرِ قوةٍ مُتعددة الجنسيات في مرحلة ما بعد الحرب، وفيما يلي طبيعة تشكيل القوة الدولية ومهامها:
مفهوم قوة الاستقرار الدولية المُؤقتة: تُعد قوة الاستقرار الدولية المُؤقتة International Stabilization Force – ISF تشكيلًا أمنيًا انتقاليًا ما زال في طور التكوين ولم يُعتمد بعد من قِبَلِ الأمم المُتحدة، وتُعرّف باعتبارها آليةً “دولية – إقليمية” تعملُ بإشرافٍ أميركيٍ لتأمين بيئة مُستقرة في غزة، حيث تتولى القيادة المركزية الأميركية إعداد خطة القوة، والتي تشملُ إنشاءَ شرطةٍ فلسطينيةٍ جديدةٍ يتمُّ تدريبها والتحقق منها بواسطة الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانبِ قواتٍ من دولٍ عربيةٍ وإسلامية وأيضًا دولية، هدفُها الأساسُ هو توفيرُ مظلةٍ أمنيةٍ مؤقّتةٍ تمكّن من إعادة الإعمار وبناء المؤسسات الفلسطينية الجديدة، وبالتالي تستمد شرعيتها من كونها ناتجةً عن تفاهمٍ سياسيٍ واسعٍ بين واشنطن وعددٍ من العواصم الإقليمية، كما تسعى واشنطن إلى تشكيل هذه القوة على أساس إقليمي، حيث تعتمد حصرًا على قوات من دول عربية وإسلامية، إذا أن هذا التكوين يهدف إلى تحقيقِ شرعيةٍ محليةٍ، حيث تعتقد الإدارة الأمريكية أن “تحالفًا إسلاميًا إقليميًا سيبدو أقل شبهًا بالاحتلال الأجنبي في نظر سكان القطاع.
المهام الجوهرية للقوة الدولية: تتوزعُ مهام القوة على ثلاثة مُستويات مُترابطة: أمنيٍ، مؤسسيٍ، وإنسانيٍ. فعلى المستوى الأمني، تضطلع القوة بتأمينِ الحدود مع الكيان الصهيوني ومصر، ومنْعِ تهريب الأسلحة، وضمانِ انسحابٍ تدريجيٍ ومنظّمٍ للجيش الصهيوني، مع توفير مناطق آمنة في جنوب القطاع كبداية للانتشار كما تتولى مهام المُراقبة الميدانية وتقييم الالتزام بوقف إطلاق النار لضمان استدامة التهدئة، أما على الصعيد الميداني، فهي مُكلّفةٌ بتدريب ودعم قوة شرطةٍ فلسطينيةٍ جديدةٍ تُنشأ بمُوافقة الأطراف المعنية، وتخضع للتأهيل من قِبَلِ مصر والأردن والولايات المتحدة، بما يعزّز بناءَ جهازٍ أمنٍي محليٍ قادرٍ على تولّي المسؤولية لاحقًا وفي المجال الإنساني، ستشرف القوة على حماية الممرات اللوجستية وتأمين سلامة المعابر الحدودية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
التشكيل والهيكل العام المُحتمل: تُشير المُعطيات الراهنة إلى أن القوة ستُشكّل من تحالفٍ إقليميٍ – دوليٍ تقوده واشنطن، ويضمُّ قواتٍ من دول عربية وإسلامية مثل إندونيسيا وأذربيجان وباكستان الذين أبدوا استعدادًا مبدئيًا للمساهمة بقواتٍ أو دعمٍ لوجستيٍ، بالإضافة إلى مصر التي ستكون شريكًا في التنسيق الميداني وتأمين الحدود الجنوبية لغزة، وهو ما يمنح القوة عمقًا إقليميًا ودعمًا لوجستيًا حيويًا، على الجانب الآخر، أعلنت تركيا رغبتها بالمُشاركة، لكنّ الموقف الصهيوني جاء رافضًا لهذه المُشاركة، حيث تركّز تل أبيب على توفير الضمانات الأمنية الصارمة، بالإضافة إلى احتمالية مُشاركة بعض الدول الغربية مثل إيطاليا التي أبدت أيضًا ترحيبًا بالمساهمة في تلك القوة، أما الأردن، فقد أعلن الملك “عبدالله الثاني” رفْضَ بلادهِ إرسالَ قواتٍ إلى القطاع رغم تأييدها السياسي للمبادرة، مُعللاً ذلك القرب الجغرافي والسياسي بين الأردن وغزة وبالتالي لا يرغب في الانخراط العسكري المُباشر، مع استعدادها لتولّي دور تدريبي للأمن الفلسطيني الجديد.
مراحل الانتشار الميداني المُقترح: وفق الخطة الأميركية، تبدأ القوة انتشارها تدريجيًا من جنوب قطاع غزة، في المناطق التي لا تسيطرِ عليها حركةُ حماس، لتأسيسِ منطقةٍ آمنةٍ تُستخدم كنقطة انطلاق لعمليات إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات. ومع استقرار الأوضاع، يُتوقّع أن تمتد مهامها شمالاً، في حين يُسمح للشرطة الفلسطينية المُدربة بالانتشار تحت إشرافها، وقد وافقت حماس على نشْرِ هذه القوة بشرط ضمان عفوٍ عن مّقاتليها وعدم مُلاحقتهم لاحقًا.
الفرق بين القوة الدولية في غزة وقوات حفظ السلام الأممية
يُمكن القول بأن القوة المُقترحة في غزة ليست مُجرّد بعثةِ حفظ سلام بالمعنى التقليدي، بل أداة سياسية وأمنية لإعادة صياغة النظام المحلي في القطاع ضمن ترتيبات ما بعد الحرب، ويُمكن إجمال هذه الاختلافات على النحو الآتي:
اختلاف الهدف والوظيفة: قوات حفظ السلام التقليدية للأمم المُتحدة صُمِّمت لضبْط النزاعات عبر المُراقبة والفصل بين الأطراف وتهيئةِ بيئةٍ سياسيةٍ لتسويةٍ سلميةٍ، مثل اليونيفيل في لبنان التي تقتصر على مُراقبة وقْف إطلاق النار ومرافقة الجيش اللبناني ضمن تفويض القرار 1701 ، أما قوة غزة المُقترحة فهدفها المُعلن هو إنفاذُ الأمن وإعادةُ تشكيل الواقع الميداني عبر نزع السلاح وضمان عدم عودة التهديدات هذا التحول من “حِفظ” إلى “فرض” السلام يجعلها أقرب إلى نموذج قوات إنفاذ الاستقرار أو ما تُعرف peace enforcement كما في أفغانستان أو الصومال، وليس بعثة مُراقبة تقليدية.
طبيعة التفويض القانوني: حيث إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المُتحدة، مثل اليونيفيل، تعملُ بمُوجبِ الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن استخدامَ القوة يكون محصورًا في الدفاع عن النفس، بالمقابل، نموذج غزة يتطلب تفويضًا بموجب الفصل السابع لتطبيق مهام نزع السلاح وتأمين الممرات الإنسانية، وهي صلاحياتٌ لا يمكن تنفيذها دون تفويضٍ أو إذنٍ باستخدام القوة، أما بالنسبة لقوات مثلAMISOM في الصومال أو ISAF في أفغانستان عملت بموجب تفويضاتٍ واسعةٍ من مجلس الأمن من خلال قرار(S/RES/1772 و S/RES/1386) سمحت بالهجوم على جماعات مسلحة وفرض الأمن بالقوة، بينما تخشى قوات الاحتلال من تفويض مماثل في غزة خشيةَ تقييد “حرية عملها العسكري” .
طبيعة المهام والبيئة العملياتية: بعثات كاليونيفيل تركّز على المُراقبة والتنسيق، وليس القتال أو فرض القانون داخل مناطقَ مكتظةٍ. أما في الصومال وأفغانستان، فقد واجهت القواتُ الأممية مقاومةً مسلّحةً مباشرةً، إذ فقدتAMISOM آلاف الجنود في معارك مع فصائل مُسلحة داخلية، أما بالنظر لنموذج غزة، حيث البيئة حضَرية مُغلقة وكثيفة السكان، ستكون القوةُ أمام مهمةٍ مُعقّدةٍ تتطلب تمييزًا دقيقًا بين المقاتلين والمدنيين، ما يُزيد مخاطرالخسائر البشرية والسياسية مُقارنةً ببعثاتٍ ذاتِ طابعٍ حدوديٍ كاليونيفيل.
شكل القيادة وطريقة السيطرة : حيث إن بعثات الأمم المتحدة تُدار عادةً تحت إشراف قائد بعثةٍ واحدٍ ويكون أيضًا تابعًا للأمم المتحدة، مما يوفّر مركزيةَ القرار وتوحيدَ قواعد الاشتباك. بينما في حالة غزة، تشير المُقترحات الأمريكية إلى هيكل قيادة مُتعددة الجنسيات خارج الأمم المتحدة، ربما بمشاركةٍ عربيةٍ وغربيةٍ، مما يخلقُ تحدياتٍ في التنسيق وتوحيد السياسات التشغيلية وهي ذات المُشكلة التي واجهتها أيضًا ISAF في أفغانستان عندما جمعت قوات من 42 دولة ذات عقائد عسكرية مختلفة .
الشرعية والقبول المحلي والإقليمي: تستندُ بعثاتُ الأمم المتحدة إلى شرعيةٍ دوليةٍ مباشرةٍ من مجلس الأمن، ما يمنحها غطاءً قانونيًا دوليًا وقبولاً نسبيًا من الأطراف. أما “قوة غزة”، فقد تُعاني من غياب القبول المحلي من حماس، وتحفّظات عربية من التورط في “وصاية أمنية”، إضافة إلى رفْضٍ الكيان الصهيوني صريحٍ لأي وصايةٍ دوليةٍ، هذا التناقض في مصادر الشرعية يجعل القوة عُرضةً للاتهام بالانحياز أو الفشل في كسب الثقة الإقليمية والدولية.
وبالنظر إلى هذه الفوارق الجوهرية تُظهر المُقارنة أن قوة غزة المُقترحة ليست بعثة حفظ سلام تقليدية، بل هي قوة إنفاذ مُختلطة ذات مهام شبة عسكرية تهدف إلى فرض الاستقرار بالقوة، وبالتالي فإن الفروقَ في التفويض والبيئة والشرعية تجعلها أقرب إلى نموذج “القوات الائتلافية” من قوات حفظ السلام أو التي تُعرف باسم “الخوذات الزرقاء”، ومع غيابِ مظلةٍ أُمميةٍ صريحةٍ وتباين مواقف الدول الأطراف، يظلُّ احتمالُ نجاحها مرهونًا بعملية التفويض القانوني، إلى جانب التنسيق مع السلطة الفلسطينية، وأخيرًا الحدُّ من المُمارسات والتدخلات الصهيونية التي تُعطّل من إنفاذها.
الدوافع والأهداف الأمريكية من تشكيلها
تسعى واشنطن عبر تشكيل القوة الدولية في غزة إلى تحقيق عددٍ من الأهداف والتي يُمكن إجمالها فيما يلي:
المُحافظة على الأمن الصهيوني عبر تحويل غزة إلى «منطقة منزوعة السلاح»: الهدفُ المحوريُ والعلني لواشنطن في طرح فكرة القوة الدولية هو إحداثُ تحولٍ بنيوي في المأزق الأمني: تحويل قطاع غزة إلى مساحة لا تُولِّد تهديدًا مُسلحًا لقوات الاحتلال هذا الهدفُ يتخذُ شكل سياسةِ نزْعِ سلاحٍ مُمنهجة للفصائل المُسلحة داخل القطاع، تُعطى للقوة الدولية ولايةً رقابيةً لتنفيذ عمليات التفتيش، جمْعِ الأسلحة، ومنْعِ إعادة التسلّح، حيث من منظور أمريكي، يُعدّ «نزع السلاح» شرطًا مُسبقًا لأي استقرار دائم، لأن أي إعادة تسليح سوف تُعيد إنتاج العنف وتستدعي تدخلات عسكرية مُستقبلية.
ضمان الانتقال المدني وإتاحة إعادة الإعمار كهدف سياسي واقتصادي: إلى جانب البُعد الأمني، ترى الإدارة الأمريكية في القوة آليةً لحماية الفضاء المدني الضروري لإطلاق برامج الإعمار وإدماج المساعدات الدولية. تَتمثّل الفكرة في أن وجودَ قوةٍ مُستقرةٍ يُخفّض من مخاطِر تدهورِ الأوضاع الأمنية ويُتيح للجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والقطاع الخاص العمل بقدر أكبر من اليقين، من هذا المنطلق، تُصاغ مهام القوة لتشملَ حمايةَ الممرات الإنسانية، تأمينَ مواقع البنية التحتية الحيوية، ودعْمَ تأسيس إدارةٍ مدنيةٍ مُؤقتةٍ أو مجالس مُنسّقة تسمح ببدء إعادة الإعمار بشكل مُنظّم وتدريجي.
خلْق دور إقليمي وتفويض الحلفاء لمُشاركة العبء الأمني: إحدى الدوافع العملية لواشنطن هي تقاسمُ العبءِ الأمني والسياسي مع شركائها الإقليميين، بحيث لا تبقى مسؤولية الاستقرار على عاتق الولايات المُتحدة وحدها، منطق السياسة الأمريكية هنا مزدوج: أولًا، إشراكُ دولٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ يمنح القوة قبولًا موسعًا وشرعيةً شعبيةً أكبر داخل العالم العربي-الإسلامي؛ ثانيًا، يُتيح لواشنطن إخراج التكاليف المباشرة وغير المباشرة من مسؤوليتِها المباشرة على المدى المتوسط. لهذا السبب تُشجَّع مشاركة دولٍ ذات حسابات داخلية أو إقليمية مختلفة.
الموازنة بين التعجيل بالانتشار وشرط الشرعية الدولية: تواجهُ واشنطن تحدّيًا عمليًا في التسريع بنشر القوة لتحقيق فائدةٍ أمنيةٍ فوريةٍ، مُقابل الحاجة إلى تفويض دولي يمنحها مقبولية ويحدّ من الاحتكاكات السياسية تسعى الإدارة إلى موازنة هذين الاستحقاقين وهما؛ الإسراع في تجهيز آليات الاستقرار لتجنيب المنطقة فراغًا أمنيًا تُمكّن الفصائل من إعادة التنظيم، مع العمل بالموازاة للحصول على قرارٍ أمميٍ أو توافقٍ دوليٍ يُشرعن المهمة ويسهّل جذْبَ مشاركاتٍ عربيةٍ وإسلامية
تفكيك قدرات الفصائل المُسلحة وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية: على مستوى السياسة العليا الأمريكية، تُستخدم قوة الاستقرار كجزءٍ من حزمةٍ تفاوضيةٍ، وذلك من خلال كونها آليةً للضغط على الفصائل المُسلحة وعلى رأسهم حماس من خلال ربط مراحل الانسحاب وإعادة الإعمار بتحقُّق معايير أمنيّة مُحددة، تتمثّل في نزْعِ السلاح، تسليم الرهائن، وأخيرًا تشكيل إدارة فلسطينية مُؤقتة.
إشكاليات وتحديات تنفيذ القوة الدولية في غزة
يوجدُ العديد من الصعوبات والتحديات بالغة التعقيد تواجهُ نموذج قوة الاستقرار الدولية المُؤقتة في غزة، وهو ما يجعل القوة تواجهُ خطر التحوّل من مشروع استقرارٍ إلى مصدر توتّرٍ جديدٍ في المنطقة، وذلك من خلال ما يلي:
الإشكالية القانونية والتفويض الدولي: أحد أبرز المعضلات التي تواجهُ إنشاء القوة يتمثّل في غياب الأساس القانوني الواضح لعملها. فإرسال قواتٍ دوليةٍ إلى غزة يتطلب تفويضًا صريحًا من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو أمرٌ محفوفٌ بالمخاطر السياسية نظرًا لاحتمال استخدام روسيا أو الصين لحقّ النقض (الفيتو) كما أن غياب حكومة فلسطينية موحدة معترف بها دوليًا، واستمرار السيطرة الصهيونية على أجزاءٍ من القطاع، يعقّدان الموقف القانوني، إذ قد تُعتبر القوة في هذه الحالة “قوة احتلال بديلة” تعمل بالنيابة عن واشنطن وتل أبيب. حاولت الولايات المتحدة الالتفاف على هذا المأزق من خلال طرْحِ خيارِ “الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف” كبديلٍ عن قرار مجلس الأمن، لكن هذا المسار يفتقر إلى الغطاء القانوني والشرعية الدولية التي تمنحها الأمم المتحدة عادة.
مُعضلة الوكالة وغياب الشريك الفلسطيني: تُعدّ مُعضلة “الوكالة السياسية” إحدى أعقد التحديات أمام تشكيل القوة، إذ لا ترغبُ أي دولةٍ عربيةٍ أو إسلاميةٍ في أن تُتهم بأنها تعمل كـ”قوة وكيلة للكيان الصهيوني في غزة ففي حال اضطرت هذه القوات إلى استخدام القوة ضد فصائل فلسطينية، فإنها ستفقد فورًا شرعيتها المحلية، رئيس الوزراء الصهيوني “بنيامين نتنياهو” أي دور للسلطة الفلسطينية الحالية في حكم غزة، مما يُبقي وستواجه حكوماتها ضغوطًا شعبيةً داخلية تطالبها بالانسحاب الفوري. وفي الوقت نفسه، يرفض فراغًا سياسيًا وإداريًا واسعًا لا يمكن للقوة الدولية ملؤه بسهولة. إذ لا يمكن لهذه القوة، مهما بلغت كفاءتُها، أن تتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية كالصحة والمياه والتعليم، وهي مهامُ كانت تتولاها مؤسساتٌ محليةٌ قبل الحرب. هذا الغيابُ لشريكٍ فلسطينيٍ فعّال يجعل القوة عالقة بين مُهمتين مُتناقضتين من حيث فرض الأمن من جهة، وإدارة الشؤون المدنية من جهة أخرى، وهو ما قد يحوّلها إلى وصايةٍ دائمةٍ بدلًا من آلية انتقالية مُؤقتة.
تحفظات الدول المُساهمة وضعف الحافز الإقليمي: إلى جانب الأردن الذي أعلن صراحةً رفضه المشاركة الميدانية رغم استعداده لتدريب عناصر الأمن الفلسطيني، أبدت دولٌ مثل إندونيسيا وماليزيا تحفظّاتٍ قانونيةً وأصرّت على صدور تفويضٍ أمميٍ قبل أي التزام عسكري. أما الدول التي أبدت استعدادًا مبدئيًا للمشاركة — مثل تركيا وقطر ومصر — فتواجه رفضًا صهيونياً جزئيًا أو كليًا، ما يجعل مهمة واشنطن في بناء تحالفٍ فعليٍ صعبٍ للغاية، حيث ترفض قوات الاحتلال بشدة مُشاركة تركيا، لأنها تخشى أن يؤدي الوجود التركي إلى ربما إنشاء قاعدةٍ عسكريةٍ قريبةٍ من حدودها، على بُعد 15 إلى 20 كيلومترًا فقط من تل أبيب، ما قد يغير ميزان القوى في شرق المتوسط بشكل جذري، خصوصًا في ظل استمرار الخطر من المُواجهة مع إيران، هذا الخلافُ يعكس اختلافًا بين الرؤية الأمريكية والرؤية الصهيونية الساعية إلى احتكار السيطرة الأمنية في غزة دون شراكاتٍ إقليميةٍ مُقلقةٍ. ونتيجةً لذلك، أصبح المشروعُ برمّته رهينةً لتجاذباتٍ جيوسياسيةٍ بين الحليفين.
البيئة الأمنية الهشة وهشاشة الهدنة: تُعدّ البيئة الأمنية في قطاع غزة أحد أكثر العوامل تهديدًا لنجاح القوة الدولية المقترحة. فالقطاع الخارج من حرب مدمّرة يعاني انهيارًا واسعًا في البنية التحتية الأمنية والإدارية، في حين تظل الميليشيات المسلحة مثل حركة أبو شباب قادرةً على الحركة وتنفيذ عمليات محدودة داخل مناطق مختلفة من القطاع. هذا الواقعُ يجعل أي هدنةٍ قائمةٍ بطبيعتها هشة وقابلة للانهيار عند أول خرق ميداني بسيط.
التعقيد اللوجستي والقيادي: تواجهُ القوة الدولية المُقترحة تحدياتٍ هيكليةً عميقة فيما يتعلق بالقيادة والسيطرة. فحتى الآن، لم تُحسم مسائل جوهرية مثل عدد القوات المشاركة، وسلسلة القيادة، والمُدة الزمنية أو الجدول الزمني لتواجد هذه القوة داخل غزة، وآلية صنع القرار، حيث تصرّ بعض الدول المرشحة على أن تكونَ المهمة محدّدة زمنيًا وواضحة الأهداف، بينما تفضّل واشنطن تركها مفتوحة لتجنب الإخفاق في حال فشل التسوية السياسية. كما أن تعدّدَ الجنسيات المشاركة — ما بين عربية وغربية — يثيرُ تحدياتٍ في توحيد قواعد الاشتباك والعقيدة العسكرية، وهي نفس المعضلة التي واجهتها قوات ISAF في أفغانستان وAMISOM في الصومال عندما واجهت مقاومةً داخليةً غير مُتجانسةٍ علاوةً على ذلك، لم يتم بعد حسم مسألة التمويل، إذ لا ترغب الدول العربية في تحمّل التكلفة المالية لمهمة قد تُفسَّر بأنها تخدم المصالح الصهيونية بالدرجة الأولى. إن هذا الغموض اللوجستي والإداري يجعل التنفيذ العملي للمهمة محفوفًا بالعقبات، ويؤجل انطلاقها إلى أجل غير معلوم.
ختامًا: تُمثّل القوة الدولية المُقترحة في غزة انعكاسًا لتقاطع الإرادات أكثر مما هي نِتاجُ توافقٍ دوليٍ راسخ؛ فهي مشروعٌ تتنازعه الرؤية الأمريكية الرامية إلى هندسة استقرار مُوجَّه يخدم الأمن الصهيوني، والمخاوف الإقليمية من إعادة إنتاج الوصاية الأجنبية تحت غطاء إنساني، وبين الطموح السياسي والتعقيد القانوني، تبدو القوة أقرب إلى أداةٍ لإدارة الأزمة لا لتسويتها، إذ يظل نجاحها مرهونًا بقدرتها على التكيّف مع واقعٍ ميدانيٍ هشٍ، وبناء شرعية فعلية تتجاوز التفويض الورقي، وعلى الرغم من أن التنفيذ الجزئي مع جمود قانوني يظل احتمالًا واقعيًا لتفادي الفراغ الأمني، فإن غياب الإجماع الدولي يجمّد المشروع في دائرة انتظارٍ مفتوحة، تُبقيه أقرب إلى تصورٍ استراتيجي قيد التداول منه إلى خطةٍ قابلةٍ للتحقق في المدى القريب.
المصدر: مركز شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية
الكاتب : دينا دومه
التاريخ : 7/11/2025
---------------------------------------------------------------------------------------
المصدر: العربية
التاريخ : 4/11/2025